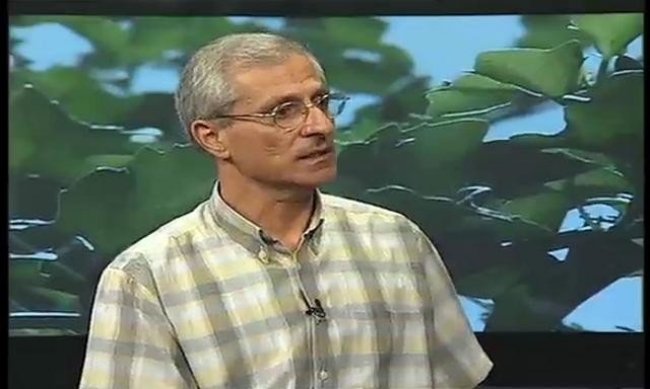
بقلم جورج كرزم
يتفق خبراء المناخ بأن الحرائق الكبيرة التي اندلعت في العديد من مناطق فلسطين في أواخر تشرين ثاني الماضي، وبخاصة في مناطق مدينة حيفا وجبل الكرمل والجليل والقدس، هي ليست مجرد ظاهرة صدفية عابرة، بل إنها حلقة في سياق اتجاه مناخي سيتفاقم خلال السنوات القادمة. ظاهرة الحرائق الآخذة في التعزز خلال أشهر الخريف والصيف، ليست حكرا على فلسطين فقط؛ بل إن حرائق غابات مشابهة وبأحجام أكبر منها كثيرا تندلع سنويا في جميع مناطق البحر المتوسط، مثل اسبانيا، البرتغال، اليونان وفرنسا، حيث تواجه تلك الدول كوارث مشابهة؛ إضافة إلى دول بعيدة أخرى مثل كاليفورنيا واستراليا. كما وفي ذات الفترة التي اندلعت فيها الحرائق الأخيرة في فلسطين، اندلعت حرائق الغابات أيضا في الأردن وسوريا.
ظاهرة حرائق المساحات الخضراء والأحراج مرتبطة بشكل أساسي بالتغير المناخي؛ ذلك أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت البداية الفعلية لفصل الشتاء تتأخر، كما أصبح شهرا تشرين ثاني وكانون أول جافان جدا وتتخللهما رياح قوية.
إضافةً إلى أن موجات الحرارة الممتدة لفترات طويلة، مع الهبوط الكبير في نسبة رطوبة الجو، كما لاحظنا مؤخرا في مدينة حيفا وجبل الكرمل والجليل والقدس، يمكن أن تتسبب في اندلاع حرائق ضخمة ناتجة عن جفاف المواد العضوية القابلة للاشتعال في الغابات؛ علما أن نسبة الرطوبة خلال فترة اندلاع حرائق حيفا هبطت إلى نحو 5-7%، ما يعد انخفاضا كبيرا وشاذا في مدينة ساحلية كحيفا. وفي المحصلة، التغيرات المناخية تتسبب في ظواهر لم نألفها سابقا.
الظاهرة المشابهة للحرائق الأخيرة حدثت عام 2010. حينئذ، وكما في فصل الشتاء الحالي، لم تهطل الأمطار حتى بداية شهر كانون أول، وبالتالي بقي الغطاء العشبي جافا طيلة تسعة أشهر. إذن، وخلافا لمزاعم الصهيوني المتطرف بنيامين نتنياهو الهادفة إلى التستر على جرائم الاحتلال ضد البيئة الفلسطينية وأنظمتها الإيكولوجية، فلا حاجة لعمليات إشعال فلسطينية متعمدة كي تندلع مثل هذه الحرائق التي تدمر، أولا وأخيرا، أراضينا وطوبغرافيتها الطبيعية الجميلة من جبال ووديان وأحراج؛ علما أن قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، هم تحديدا الذين "تفننوا" و"يتفننون"، منذ عشرات السنين، في حرق وتجريف وتدمير عشرات آلاف الدونمات من أراضينا الزراعية، أثناء اعتداءات المستوطنين والتدريبات العسكرية، وإنشاء المشاريع الاستعمارية العنصرية من جدران عازلة وشوارع وأنفاق وجسور، واقتلاع ملايين الأشجار والأشتال، وقصف وتدمير أخصب الأراضي الزراعية في قطاع غزة من الجو والبر والبحر بالفسفور الأبيض والمواد الكيميائية والمشعة القاتلة، كما حصل مراراً في الحروب العدوانية التي شنتها إسرائيل في السنوات الماضية.
ولا بد من التذكير هنا بالحرائق الضخمة الخطيرة جدا التي اندلعت في السنوات الأخيرة في مناطق مختلفة بفلسطين، كما حدث مرارا في الأغوار الفلسطينية والجليل والجولان المحتل؛ فحرقت الأخضر واليابس وخربت مكونات عديدة في الحياة البرية، بسبب النشاطات والتدريبات العسكرية المكثفة للجيش الإسرائيلي الذي احتل المكانة الأولى دون منازع في عمليات حرق وتدمير المشهد الطبيعي في فلسطين.
إذن، جزءٌ كبير من النسيج الحيواني والنباتي الفلسطيني الثري والجميل دُمّر؛ ليس بفعل عوامل طبيعية وبيئية بالدرجة الأولى؛ بل بسبب الاحتقار الإسرائيلي للقيم الطبيعية والبيئية، وإهمال إسرائيل الواضح لدورها في الحفاظ على البيئة الفلسطينية والمحميات الطبيعية، وعدم تخصيصها الموازنات اللازمة لصون الحياة البرية في الأراضي الفلسطينية والعربية الرازحة تحت احتلالها.
الحرائق الضخمة ستتعاظم
الحالة الشاذة الإضافية التي ميزت الحرائق الأخيرة هي تأثير الرياح الشرقية، خلافا للرياح الغربية التي تميز الحرائق في فلسطين. وقد تجلى هذا الأمر، على سبيل المثال، في مناطق القدس التي اشتعلت فيها النيران؛ إذ أن النيران التي تتقدم باتجاه سفح الجبل تكون أكثر بطأً من النيران التي تتحرك إلى أعلى. فلو كانت الرياح غربية، لكانت الكارثة الطبيعية أفظع بكثير.
الحقيقة أن ظاهرة الحرائق الضخمة خلال فصل الخريف، قد تتعاظم كلما ازداد تأثير الاحترار العالمي؛ ما يعني أننا قد نشهد في بعض المناطق الفلسطينية تغيرا دراماتيكيا في المشهد الطبيعي، وهذا بالضبط ما هو حاصل في جبال القدس. ففي الماضي غير البعيد، كان غطاء الغابات يملأ كل المنطقة الغربية في القدس؛ أما اليوم فغالبية تلك المنطقة عبارة عن بقع اختفى عنها ذلك الغطاء الذي قد لا يعود. فيكفي التجول السريع في منطقة عين كارم في القدس (منطقة مشفى "هداسا") لنرى بأنه بدل التنوع الشجري (وبخاصة الصنوبر) الذي كان قائما حتى قبل نحو عشر سنوات، لا يوجد اليوم سوى مساحات كبيرة تغطيها نباتات قصيرة متناثرة تخترقها المصاطب العتيقة.
لكن، ومع ذلك، يمكننا القول بأن الطبيعة قد تعيد تنظيم ذاتها مع مرور الزمن، فتعيد إنبات الغطاء الأخضر؛ إذ أن الواقع حتى الآن لا يعد كارثة غير قابلة للإصلاح، خلافا للتمدد الإسمنتي على حساب المساحات الشجرية والخضراء؛ فآثار الحرائق على الطبيعة قابلة للإصلاح.
في الواقع، الحرارة الناتجة من الحرائق الكبيرة تساهم في تسخين الغلاف الجوي. كما أن انبعاث كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون الناتج عن تلك الحرائق يزيد من أثر الدفيئة. إضافة إلى أن فقدان أشجار الغابات بسبب الحرائق، يعني فقدان القدرة على امتصاص الكربون من الغلاف الجوي وتثبيته. وفي المحصلة، يزداد ميزان ثاني أكسيد الكربون سوءا ويزداد تراكمه في الغلاف الجوي.
الأبحاث الأخيرة المتعلقة بنظام درجات الحرارة والأمطار المتوقعة في فلسطين، تقدر بأن تتواصل الزيادة في شدة وتكرار الجفاف والحرارة المتطرفين ولفترات أطول من تلك التي عرفناها حتى الآن. وهذا يتطلب إعادة ترتيب الأولويات الوطنية؛ مع اتخاذ إجراءات التكيف مع المناخ المتغير، بما في ذلك تحسين الجاهزية الوطنية لمواجهة الحرائق الضخمة.
ثغرات وعيوب بيئية وأمنية استراتيجية
في سياق نقاشنا لظاهرة الحرائق والاحترار العالمي، من الأهمية بمكان التنويه إلى كتاب الباحث في معهد "التخنيون" الإسرائيلي (معهد الهندسة التطبيقية) البروفيسور يوسف جبارين (من مدينة أم الفحم) بعنوان“The Risk City” الذي تضمن بحثا مقارنا للمدن الكبيرة في العالم، مثل باريس، لندن، نيويورك، موسكو، بيجين وغيرها، والتي تسَبَّبَ تغير المناخ الناتج عن التلوث الجوي منذ انطلاق الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر- تسبب بكوارث مناخية وإيكولوجية في تلك المدن؛ بما في ذلك العديد من العواصف والأعاصير التي ضربت بعضها، كما حدث أكثر من مرة في مدينة نيويورك التي تدمرت واحترقت مئات المباني فيها بسبب الأعاصير (إعصار ساندي على سبيل المثال). وتطرق الكتاب إلى مدينة حيفا التي تحولت بدورها إلى مدينة خطر. ولتوضيح السيناريو المناخي الكارثي المتوقع لهذه المدينة الفلسطينية، احتوى الكتاب خريطة بالحرائق المتوقعة الناتجة عن التغير المناخي.
اللافت أن مقارنة الحرائق الأخيرة في مدينة حيفا وجبال الكرمل، بتلك التي وردت في خريطة جبارين، تؤكد دقة التحليل العلمي للباحث. ليس هذا فقط، بل ناقش الكتاب السيناريوهات المتوقعة للدمار في حيفا، بسبب الارتفاع المتواصل في مستويات سطح البحار بمناطق مختلفة في العالم؛ ما قد يؤدي (بحسب الكتاب) إلى حدوث "تسونامي" بحري سيغرق أجزاء من البلدة التحتا للمدينة. وعالج الكتاب أيضا، المخاطر الكارثية المحتملة لدى انتشار الغازات السامة، وبخاصة الأمونيا.
الحقيقة الساطعة التي تجلت في حرائق تشرين ثاني الماضي، وللمرة الثانية خلال أقل من ست سنوات (أي منذ حرائق جبال الكرمل عام 2010)، هي أن إسرائيل التي سوقت ذاتها وبعجرفة قل نظيرها، باعتبارها قوة عسكرية وتكنولوجية واقتصادية "لا تقهر"؛ عاجزة عن السيطرة على تلك الحرائق بقواها الذاتية؛ دون توسل المساعدات الخارجية والجسر الجوي المكثف؛ ما كشف ثغرات وعيوب بيئية وأمنية إستراتيجية حساسة في إسرائيل لم يتوقعها الكثيرون.
الميزانيات المالية الضخمة التي خصصتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة لمشاريعها العسكرية المعادية للعرب والفلسطينيين، لم تسعفها في مواجهة الحرائق الأخيرة (تشرين ثاني 2016)، ومن قبلها حرائق الكرمل (2010) التي حاولت قوى الإطفاء الإسرائيلية إطفائها بطرق بدائية، بواسطة خراطيم المياه الأرضية؛ علما أن المساحات التي امتدت إليها الحرائق في الحالتين (نحو 50 ألف دونم عام 2010، وحوالي 41 ألف دونم عام 2016)، تعد بالمقاييس العالمية صغيرة نسبيا؛ لو تمت مقارنتها بالمساحات الاسترالية والروسية واليونانية والأميركية وغيرها الأكبر بكثير، والتي اندلعت فيها مرارا حرائق ضخمة. ومع ذلك، إذا استغرقت فترة السيطرة على الحرائق الأخيرة أكثر من أسبوع، ومساعدة عشر دول، فليس صعبا أن نتخيل حال هذه القوة "العظمى" الإسرائيلية في منطقتنا العربية، لدى اندلاع حرب طاحنة وانهمار مئات الصواريخ يوميا في عمقها، وما سيترتب على ذلك من حرائق وانفجارات ضخمة وانبعاثات غازية مرعبة (الأمونيا في حيفا على سبيل المثال).